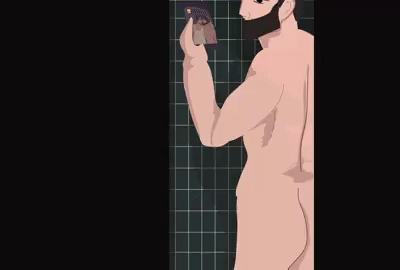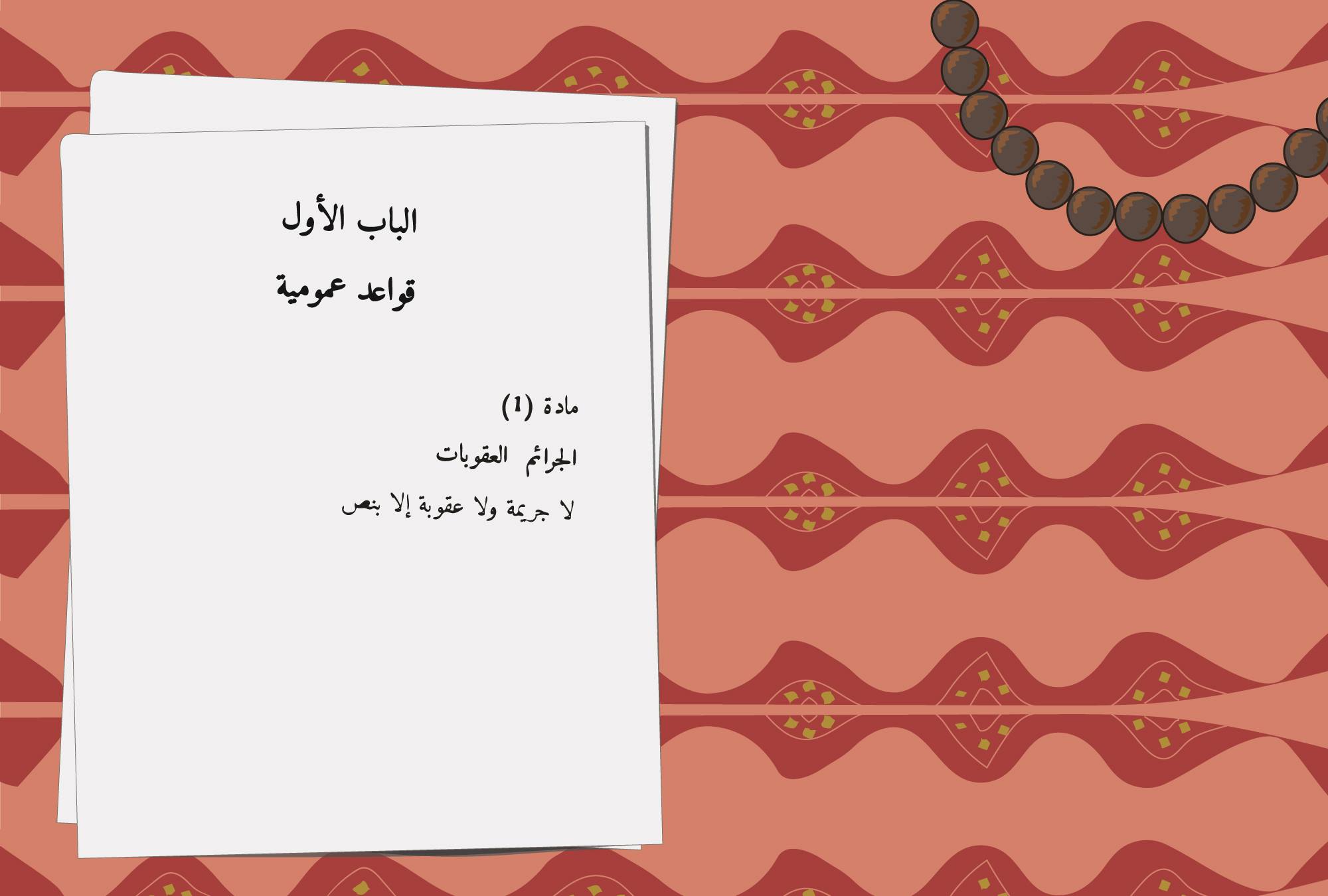تاريخيًا وحتى وقت قريب، غالبًا ما تم الخلط بين الهوية الجندرية للفرد والميول الجنسي، كما استعملت الأدوار والتعابير والمؤشرات الجندرية- تسريحة الشعر، شكل الجسم، المشية، التعبير الجسماني، الصوت، شعر الوجه والجسم، …إلخ. (قد يختلف تصنيف هذه المؤشرات حسب البيئة المجتمعية والثقافات) للتكهُّن بهوية الفرد الجندرية أو الجنسية. من المصطلحات البائدة والتي لازالت تستعمل في مجتمعاتنا العربية لوصف مجتمع الميم مصطلح الـتومبوي أو الفتاة المسترجلة (بالإنجليزية: Tomboy) وهي كلمة تطلق على الفتاة التي تتشبه بالرجال في خصائصهم وسلوكياتهم وطريقة لباسهم، أيضًا تطلق على الفتيات اللواتي يشاركن في الألعاب والأنشطة التي تحتاج إلى قوة بدنية وتعتبر في كثير من الثقافات حكراً على الذكور. ويطلق عليهم غالبًا باللغة العامية في بعض مدن ليبيا مصطلح (عِيشة راجل) وتستعمل كخلط سافر بين الهوية الجنسية والحندرية وتعابير الفرد، فهي تطلق على النساء (هوية جندرية) المثليات (هوية جنسية) اللاتي يمارسن أو يظهرن تعابيرًا ينسبها المجتمع للرجال (كالشعر القصير، الصوت الخشن، ممارسة الرياضات التي يعتبرها المجتمع ذكورية، دراسة تخصصات علمية معينة.. الخ).
“اسمي سهى (اسم مستعار)، (ضاحكةً) أو “ناجي” كما تدعوني صديقة والدتي، أنا مثلية، عمري 20 عام، أدرس بكلية الهندسة، لم تكن هذه رغبتي، حقيقةً لا أعرف ما هي رغبتي حتى الآن، لي العديد من الإهتمامات، لا أستطيع وصف نفسي، لأن سؤالًا كهذا يحتاج شخصًا يفهم نفسه بشكلٍ كافٍ لوصفها، لذا، سأصف نفسي كما يراني الآخرون:
أدركت، منذ طفولتي، أنني مختلفة، لا أستطيع التوضيح، لكن كان ذلك ظاهرًا في صوتي، شخصيتي، كلامي، أو في ميلي لإنشاء صداقات مع الأولاد أكثر من البنات. كنت الأفضل في كرة القدم، ولازلت حتى الآن، علَّمني لعب الكرة جارٌ لنا، كان يصطحبني لمكان ندعوه “العزّابة” في الشرق، وهو مكان مخصص للرجال وكنت ألعب هناك.
لطالما أحببت الدراجات. لي خبرة كبيرة في ركوبها وفكِّها وتركيبها، عمومًا أحب إصلاح الأشياء، لا يخرب زر في البيت إلا أصلحته.
أتجاذب الحديث مع أقربائنا الذكور عند زيارتهم لبيتنا، بعد رحيلهم، يتملّقون أمي قائلين “ما شاء الله ذكية بنتكم” لأنهم دائمًا يتوقعون نمطًا معيّنًا لحديث النساء.
مارست الكثير من العنف الجسدي في طفولتي، كنت معجبة بجارتنا التي تقدم دروسًا خصوصية في منزلها. (ضاحِكة) اللي يجي شورها (من همَّ بمضايقتها) ويعاكسها نمشي نهزبه (أُعاتِبه) ونضربه ثم يأتي أهله مُتشكِّيِين. كنت عنيفة في الماضي لكن قيَمي الإنسانية تغيَّرت الآن.
أما هويتي الثقافية، فأنا من قبيلة بدوية، من الوادي الأحمر بليبيا، أعشق الغنم والإبل وموسم الجلامة (هو موسم جز صوف الغنم، ويقع قبل شهر من الصيف).
كيف تراني عائلتي؟
قبل ست سنوات، أحببت بجدية لأول مرة، أحببت فتاة من طرابلس، وامتلأت حسابات التواصل الخاصة بي بالأشعار والأشجان. أثار ذلك الشك لدى أُختَيْ، استغلَّتا وقت نومي وقامتا بتفتيش هاتفي، راعَتهُم رؤية المحادثات بيني وبين صديقتي وهي فتاة مغايرة، كانت بيننا كيمياء، لا أدري لمَ ولكن ربما لأنها أحبت الإهتمام المفرط الذي وجهته لها. استيقظت ووجدت أختاي تتهافتان على هاتفي وسألْنَنِي”شن (ما) اللي تكتبي فيه هذا؟”، لم أعطيهن بالًا وعدت لأنام، أستيقظت مجددًا على ثورة غضب أمي التي ضربتني، كان شعورًا قاسيًا، بَكِيت وتَنَاسَيْت، سواءًا اكتشفوا أم لا، لم أعترف بصراحة بكوني مثلية، أذكر أنني اتبطت بصديق مغاير في تلك الفترة، لا لشيءٍ إلا للتستر على ما حصل، ولسوء حظي، استطاع هو أيضًا أن يحصل على كلمة المرور لحسابي واكتشفت محادثات بيني وبين نساء أخريات، كان موقفه رهيبًا، إذ هرع لإخبار عائلتي واضطررت مجددًّا للكذب والإنكار. لم يستطع إيذائي كما أراد، وقطعت علاقتي به تمامًا منذ ذلك الوقت.ليس لأحد الحق في الإفصاح عن هويات الآخرين دون رضاهم! مهما كان السبب.
علاقتي بأسرتي مختلفة، أختي الكبرى لم تعاني من رهاب المثلية تجاهي، أما الاخرى فكانت تحمل دولا الكَارِه منذ البداية، منذ ثلاث سنوات، صارت تناديني “ليزبو” بنية الإهانة، لم أشعر بالإهانة وأكَّدتُ قائلة: “نعم، أني هكِّي (هكذا)”، أخبرت والدتي فعاتبتني وانتهجت معي منهج العنف مجددَا، ثم شعرت بالندم وأرادت أن تفهم مني المزيد، لم تَعِ أمي ما تعنيه هذه الكلمة أو كوني مثلية. أتذكر أنها في فترة ما كانت تمدح لي مفاتن الرجال ولحاهم وصدورهم، فأجبتها تلقائيًا “وكان تعرفي قداش (كَمْ) صدُور الصَّبايا حِلْوات” فشَهِقَتْ بالضحك، أمي شخصيًّا لا تدعم كوني مثلية، لكن ما يُهم بالنسبة لي هو أنها تعلم، وأن موقفها ليس سلبيًا تجاهي. ما يُهم هُنا هو أنَّها تُحاول.
كيف يراني المجتمع الليبي؟
بإمكانك تخيُّل الموقف حين تنظر إليكِ إحدى الفتيات في الجامعة باشمئزاز لا لشيء إلا لأنكما مارستما الجنس بالتراضي في أحد الأيام، ليس لدي أصدقاء مثليون/مثليات، أعرف الكثير من أفراد المحتمع الكويري ولكن لسنا علاقة مقرّبة.
بالنسبة لمَسَالِكِي اليومية، أدرس بجامعة في منطقة بين اجدابيا وسرت، بعيدة عن منطقة سكني 40 كيلو مترًا، أقود سيارتي يوميًا جيئةً وذهابًا إلى هناك، أحاول الإبتعاد عن الجلسات الاجتماعية بين المحاضرات أو التجوال في الجامعة تفاديًا لتنمية أي مشاعر لإحدى الفتيات أو الوقوع في مشاكل بسبب ميولي المختلف.
في الفترة الاخيرة، صِرتُ أعتاد طرابلس بكثرة، ولاحظت استغراب الناس من شكلي، ذات مرَّة ذهبت لزيارة طبيبة وسألتني: أنتِ “سهى”؟! فأجبت بنعم، فسألت مجدَّدًا باستهجان: “إنتَ ولا إنتِ؟” ما كان منِّي إلَّا أن أجيبها “انتِ”.
وفي موقفٍ آخر، كنت على الطائرة عائدة من طرابلس، قابلتني امرأة مسنَّة تحمل أمتعة ثقيلة فعرضت عليها المساعدة، سَعِدَتْ بمساعدتي لها وجلست بجانبي، افتتحت الحديث بسؤالي عن دراستي وكانت تستعمل صيغة المذكر في حديثها، لم أُرد إرباكها فتجاهلت هذا الخطأ، أخبرتني عن حياتها وتفاخرت ببناتها وإمتيازهنَّ عن بنات هذا الجيل “بناتي قاعدات في الحوش (المنزل)” في مشهد ساخرٍ بُني على ظنها أنني رجل مهذب وجيد الطباع قد يكون عريسًا جيدًا لإحدى بناتها. بعد هبوط الطائرة، ساعدتها في حمل أمتعتها للخارج، وهنا ما كان مني إلا الهروب بسرعة تفاديًا للموقف المحرج الذي اكتشفت فيه لاحقًا من والدتي أنني امرأة.”